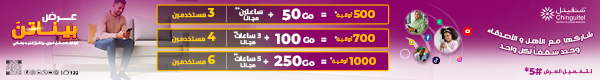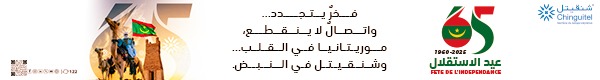مقالات في الفهم والتدين والسياسة الحلقة(1).
في بلدي فإن دعاة الحرية والعدالة والتطور والتشبث باحترام الثوابت وتطوير المشروع الوطني يسيرون في التنظير والتخطيط على تيه من الحداثة وبرزخ من القيم الموهومة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ .
ففي بحثهم الدءوب والجاد أحيانا عن الثوابت القيمية الراسخة الحامية من الانجراف، كثيرا ما يلجأ الساسة عندنا إلى متغيرات يحسبونها ثوابت ذا قيمة وجودية ضامنة...
وما هي عند التحقيق والدراسة والاختبار بذلك، بل إنها في الغالب الأعم والواقع الأكثر علمية كثيرا ما تكون مجرد حلول لأعراض مشاكل أقل ما يقال فيها أنها لم تعد قائمة ولا ذا قيمة في حياة المجتمع وبنائه، وإن كانت في مظهرها وشكلها تمثل نوعا من الإجابة عن أسئلة لم تعد مطروحة، ويحمل كل ذلك اعتقاد البعض على أنها قيم حداثة ودين وما هي من الدين بشيء ولا من السياسة ولا القيم الأساسية للحداثة؟!
وآثار تلك القراءات التائهة والتصورات المخبولة يشكل خطرا حقيقيا على الثقافة والسياسة والاقتصاد والاجتماع للمجتمع، فضلا عن كونها من أهم كوابح أنواع التطور والبناء، ومن أكبر معيقات حتى التوافق الاجتماعي ، ونحن في هذه القراءة والمعالجة شبه النقدية سوف ندخل إلى بعض هوامش دوائر المحظور الذي يتهيب أكثر الباحثين والسياسيين من دخوله، لأنه شديد الصعوبة والخطورة لكونه تدخل في دوائر المحظور من مفاهيم تعتبر جزءا من الاعتقاد عند بعض الناس ومفهومهم عن ما يحسبونه مقدسا من ثوابتهم ؟!
أولا: مفهوم وتضخم المقدس: كثيرا ما عانى أتباع الديانات السابقة من داء "تضخم ما جعلوه هم مقدسا" الأمر الذي أدى دائما إلى نشوب الحروب وإنتاج أسباب الكراهية والكوارث وشرور التي تمت لها في الحياة السيطرة التامة، الأمر الذي هيأ للغرب اليهودي والمسيحي فيما بعد أن حسم أمره عبر صفقات تتنازل بموجبها مجامع الدين وهيئاته للدولة الحديثة العلمانية عن السلطان الأعلى على الأبدان والأموال وحرية المعتقد، فيما تنازلت تلك الدولة للهيئات والمجامع عن مجرد الوجود والبقاء، وإن جنح أتباع الديانة اليهودية لمكر وخبث التحالف والانتصار للدولة بغض النظر عن مرجعيتها وعلى قاسم مشترك هو الأرض ولو كانت مسروقة والوطن ولو كان مغصوبا ؟.
أما العالم الإسلامي فإنه ظل يخوض صراعا مفروضا في معركة البقاء والوجود لا يملك فيه رؤية حضارية ولا قدرة على حسم أمره وتدبير شأنه، سواء تقليدا أو اقتباسا لأي من النموذجين الغربيين المسحي واليهودي، وربما كانت الموانع والمبررات والأسباب كثيرة، ولعل من أهمها وأبرزها على مستوى القيم والفاعلية في الحياة:
أولا: غياب الرؤية الدينية الحقيقية في الإنشاء والاعمار، بل وفي غاية الوجود الإنساني في هذه الحياة، فالدين أصبح خليطا من الوحي والخرافة والشعوذة، والتدين: مزيجا من بقايا الدين والعادات والتقاليد ومخلفات القهر والظلم والفساد ؟.
ثانيا: ضياع وضعف التكوين العلمي العام، وندرته في صفوف الزعامة والقيادة، وكذلك فساد البيئة التي يعيش فيها العالم أو المثقف ويتفاعل معها الإنسان العادي، والانتشار المتزايد لغير المتعلمين في صفوف الفئات القيادية للمجتمع .
ثالثا: ضعف الأبحاث العلمية روافع الحضارة وفواعل الاعمار والتنمية، وخاصة منها تلك التي تروم المقارنة المتعلقة بالمجال الديني وتقديم أغلب العلوم والمعارف بمعزل عن بعضها وفصل العلوم الشرعية عن سياقاتها التاريخية ونسقها التشريعي .
رابعا: التعامل مع" العلوم الشرعية "من حيث الأهداف والغايات بصفتها فقط وسيلة للتبرير والشرعنة للخيارات الفكرية المنبثقة عن العادات الاجتماعية وعن المواقف السياسية المحكومة من قبل الحكام ومعارضيهم على السواء، كل هذا – ومعه غيره – لم يتح لأغلب العلماء والمثقفين والدعاة إمكانية فهم النص الديني الحقيقي ضمن سياقه الذي نشأ فيه، وتمييز ما هو مقدس وثابت مؤبد فيه عما هو متغير ونسبي، وما هو من العادات والتقاليد وغريب على قيم الدين وشروط المدنية والحداثة، الأمر الذي سيسمح في النهاية بحسم الموقف الحضاري باعتماد آلية علمية شرعية تحمل وتحمل الإنسان مسؤولية التغيير والتطوير ودونما تضيع أو تهميش للمقدس أو تضخيم لما ليس بمقدس أصلا في الفقه والدين والحياة .
وهذه المنهجية التائهة والفهوم الضائعة كانت ولا زالت هي المسئولة عن عدم الحسم في التطور والبناء، كما وهي السبب المباشر في وجود وتزايد مظاهر التفكك وخلق مختلف أسباب الصراعات المذهبية والفئوية القاتلة والمدمرة، وهي صراعات تشتد في بعض الفترات وتكمن في أخرى، وأسبابها موجودة في بنية المقدس المصطنع ومظاهر الاجتماع وقوانين العلاقات ووظائف الدورة الاقتصادية، ومن حين لآخر تتم إعادة تشكيلها وبعثها وفق رؤية الحاكم وسياسة الحكم وخاصة ما بعد حكام وأنظمة ما يسمى بالتحرر من الاستعمار، والقابلية لها مترسخة أصلا في نمط التفكير الإسلامي من عهد عصور الانحطاط متجلية وحاضرة في حيات ونمط تفكير أغلب الجماهير الواسعة من المسلمين شمالا وجنوبا مع الحضور الفاعل والدائم لغياب أبجديات التوافق على بعض الأهداف المدنية ألازمة الكبرى أو المقاصد الشرعية العليا، الأمر الذي فرض على الناس الضياع في متاهات القشور والجزئيات التي تستنفذ الجهود وتشتت الطاقات، ولا تقدم سبيلا للتطور والرقي والنماء، وشغل الناس بخلاف الفقهاء في جدالات زيارة القبور والتبرك بها والقبض والسدل وتحريك السبابة، ومفهوم ولي الأمر وأشكال الطاعة ألازمة، وأحكام الغناء والتصوير والنحت، وأشكال اللباس، والمأكل والمشرب، وتعدد الزوجـات، والعقوبات وتصنيف الحدود، وحقيقة وأحكام الجهـاد، ومدى عقدية الولاء والبـراء ، وصنوف التدين وأنواع التجديد في الدين عندهم محصورة في ذلك به يسلم السلف الخلف المشعل(أغلب حركات البعث الإسلامي- وخاصة السلفي).
والطرف المقابل من الأمة غارق فيما يسميه مشكل الهوية وسمو النوع ورقي الجنس(التيارات القومية)، أجيال تتوارث أجيال أخرى تعيد اجترار نفس القضايا بوسائل جديدة وربما أضافت إليها غيرها بحكم هجوم الحضارة ومواجهة الجديد من القضايا والنوازل التي ينقسم الناس أماها إلى فسطاطين في التعامل معها أو عدمه كالمؤسسات البنكية ومقومات الدورة الاقتصادية الجديدة مثل عقود التأمين وأنواع القروض وصيغ الاستثمار، والتعددية السياسية والديمقراطية وحركات التفكير والعمل السياسي ومقولات الحداثة والعلمانية، فتشتعل الحرب بين هواة الفسطاطين ما بين محلل ومحرم كل بلغته وأسلوبه فيشغلون ويلهون بذلك عن التفكير والإبداع وإنشاء الجديد المفيد من الحلول والبدائل للقضايا المعاصرة التي تواجههم وتلح عليهم إلحاحا، وما لهم إلى ذلك سبيل وقد غاب من حسهم ووعيهم وتفكيرهم إدراك أهمية وضرورة المقاصد العليا للحياة ومرتكزات التطور والبناء، وليت الأمر مقتصرا على"جماعات المتدينين" تقليديين والحركيين المتطرفين والمعتدلين، لهان الخطر ولسهل الخطب، ولكن الداء أشد وأخطر في حياة أغلب من يوصفون بالمثقفين الحادثين والعلمانيين والذين نصب أغلبهم نفسه حاكما على أفكار الناس وتوجهاتهم ومعتقداتهم، فهو يمارس نفس عمليات التحليل والتحريم بل والتبديع والتكفير والإقصاء والقتل بأسلوبه ومنهجه ولغته، ومن خلال منهج، وقاموس ومفردات مغايرة للقاموس الديني عند المتدينين لكن النتيجة واحدة، وهو في ذلك غارق ومنشغل أشد الانشغال، ومعتبرا في نفسه أن المطلوب منه والواجب عليه هو إنتاج وسائل وإصدار أحكام قيمية فكرية يزن بها تناقضه واضطراب تفكيره في القومية والحداثة والعلمانية، وقد أعماه ذلك عن النظر العلمي إلى ما يتطلبه الواقع من إبداع جديد أو ابتكار حديث، الأمر الذي فرض علينا اليوم أن نعيش حالة قروننا الوسطى من جديد.
وإذا كانت مقتضيات ماضي أهل الدينات والوثنيات قد فرضت عليهم ظرفها ومقتضياتها توسيع دائرة المقدس بحكم أنه من صنع البشر كحال القوميات والأيديولوجيات عندنا، فإن تلك المقتضيات والأسباب والضروريات لا توجد في منظومتنا التشريعية وقيمنا الحضارية، وإن ظن البعض على سبيل المثال أن الفكر الأصولي للإمام الشافعي ولضرورات تدبيرية في الفقه والسياسة والاجتماع وعبر آليات تثبيت أخبار الآحاد والقول بالقياس والإجماع، قد خضع لتلك السياقات وتعامل مع تلك المقتضيات الأمر الذي يعطي الوجاهة والتبرير للواضعين والصانعين لتلك المقدسات التي ظهرت فيما بعد عند أغلب الأفراد والجماعات من عصر الانحطاط وحتى ما يسمى بعهد التحرر والتنوير؟! ...
إلا أن الوافد المستوطن من أفكار ومناهج الغير المسيحي على وجه التحديد أوجد لوازم وحتى إكراهات تقول إن الأمر لم يعد كما كان على حاله وذلك بتغير سياقات التطور وضرورات الحياة وحتى تطورا لاحتياجات والإجراءات التشريعية والتنفيذية على مستوى الوجود العالمي، فضلا عن تطور وسائل الكشف عن الإرادة العامة وتحمل المسؤولية وحترامها ثقافيا وتفعيلها تشريعيا وتنفيذيا، مما يجعل استمرار الاتكاء على ما يسمى بحماية المقدس في التدبير والتسيير السياسي والاجتماعي نوعا من الهروب من تحمل مسؤولية التفكير الحضاري والتدبير الحياتي وتحميلها لمن هم أكثر تقنية وعلما وفهما من ما مضى من سلف الأمة المزعوم ؟
والواقع أن توسيع دائرة المقدس بحثا عن وسيلة يتم بها تنظيم وتدبير وضبط الحركة الاجتماعية كثيرا ما قوبل بردود أفعال مضادة استخدمت فيها القداسة أيضا فيما هو غير مقدس من مصالح اجتماعية وفئوية، ولا يخرج نشوء الفرق وتوالي انقساماتها عن هذه العقلية الباحثة عن الإلزام الاجتماعي وتوظيف المقدس في ذلك، فلم يكن الأمر أبدا من دون مخاطر على الدين والحياة . يتابع...