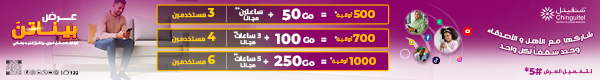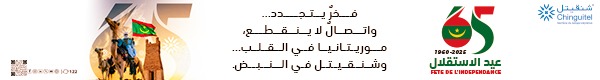بعد أيّام قليلة تبدأ دورة أخرى من مسلسل الهروب إلى الأمام، بزيادة عام دراسي جديد إلى سبع وخمسين حِجّة خلت، ولد التعليم فيها كسيحا، ثمّ كاد أن يشيخ دون أن يبلغ الحلم، وتلك ـ لعمري ـ مفارقة عجيبة.
في هذا العالم الذي يحيط بنا ظهرت اقتصادات قويّة، وبُنيّت ديموقراطيات عريقة، وازدهرت العلوم والتكنولوجيا، وكثرت الصناعات، وتمّ غزو الفضاء، واستتبّ الأمن وترسّخ العدل، وتعزّزت حقوق الإنسان، وانتقل الاقتصاد بالتدريج من اقتصاد الثورة الزراعية إلى اقتصاد الثورة الصناعية إلى اقتصاد الثورة المعرفية التي أساسها العقل البشري، فتحوّل الفقراء في مناطق عديدة إلى أغنياء، وعاش الناس في دعة. كلّ ذلك وغيره حصل من حولنا بفضل جودة التعليم وتنمية المواهب وشحذ الأفكار، وخلق الموارد البشرية القادرة على البناء والتطوير، أمّا نحن هنا فما زلنا نحسن التفرّج، وكأنّنا " لا في العير ولا في النفير".
ولأنّ تعليمنا بعض واقعنا المرّ والمرتبك، فقد ظلّ يتقدّم خطوة ويتراجع خطوات، صحيح أنّه أقيمت منشآت تعليمية مختلفة، وكُوّنت كوادر بشرية عديدة، وظهرت مخرجات تعليم متأرجحة، ووضعت سياسات وإنْ على الورق، بيد أنّ ذلك كلّه لم يسعف تعليمنا بشيء يذكر، فما زال مؤشّر تدنّي التعليم عندنا للأسف من أسوأِ ما يكون في العالم، والقاسم المشترك بين ما حصل من "إنجازات" إذا استثنينا المرحلة التي قادها الزعيم المؤسّس، رغم طفولة المشروع آنئذ وشُحّ الموارد، هو الفوضى والارتجال والدعاية المغرضة. وهنا مكمن الداء، إذ المعروف أنّ التعليم قطاع فنّي حاسم واستراتيجي، ينجح بالخبرة والتخطيط، ويفشل بالتذبذب والمزاجية.
فالتعليم عندنا فوضوي حين يُدار بمزاجية الفرد، فلا أهداف ولا تخطيط ولا استشراف، بل يُساس بسياسة النعامة، فيتولاّه من لا يعرف حقيقته ولم يعش ظروفه وأوضاعه. وليست له رؤية واضحة، ثمّ لا يستعين بالخبراء والكوادر المختصّة، وإن فعل ـ وقلّما يفعل ـ فعلى سبيل الاستئناس والمزايدة لا غير. وفوضوي حين تكتنف اكتتابَ المدرّسين وترقيةَ المؤطّرين في بعض الحالات شُبُهاتُ التزوير والوساطة والزّبونية، فتكون النتيجة مدرّس أَوْلَى من غيره بالتدريس، ومؤطّر لا يفقه من أمر التّأطير إلاّ ما يزيد به الطّين بِلّة. والأخطر يكمن في التراجع التدريجي عن مبدأِ اكتتاب المدرّسين والاعتماد على العقدويين عديمي الخبرة والتجربة، وهم الذين باتوا يمثّلون النسبة الأعلى في المدارس النظامية، وممّا يندى له الجبين في هذا السياق أن تجد خرّيج القانون يُدرِّس التاريخ والجغرافيا والتربية الإسلامية واللغة العربية، وخرّيج الاقتصاد باللغة العربية يُدرِّس الفيزياء والكيمياء والعلوم والرياضيات باللغة الفرنسية وهلمّ جرا. وفوضوي في هدر طاقته المتدنّية أصلا، على مستوى الموارد البشرية والبنية التحتية، ففي الأولى يُسَيّبُ المدرّسون ويُفرّغون ويُحالون إلى قطاعات حكومية أخرى ليجدوا فيها الراحة والحظوة، وفي الثانية تقام المؤسّسات ـ على قلّتها ـ لأغراض دعائية وانتخابية بحتة في القرى والتّجمّعات المهجورة تقريبا، وتُصرَف عن أماكن تحتاجها بالفعل وذات كثافة سكّنية عالية، وقد تُجعل في أماكن توفّرت فيها الخدمة سلفا، ويُحرم منها الذين هم في أمسّ الحاجة إليها، في القرى و"أدوابه" على وجه التحديد.
وتأتي كارثة خصخصة التعليم ـ إذا استثنينا بعض المؤسّسات الخاصة التي أثبتت نجاحها ـ لتمثّل قمّة الفوضوية، ولتُجهز على ما تبقّى من أمل في إصلاح هيكل التعليم المنخور، فقد انتشرت "حوانيت التأليم" ـ لا التعليم ـ التي فاقت التصوّر وغصّت بها الأحياء السّكنية في المدن الكبرى، فما يميّزها هو هاجس الربح، بينما المسئولية التربوية والأخلاقية والاجتماعية مقامها الأخير إن كان لها من مقام، وتتميّز أيضا بهشاشة بنيتها التحتية التي أعدّت في الأصل مساكن لا مدارس، ثمّ بضعف الطاقم التربوي المشرف، والذي كثيرا ما تكون قذفت به صروف الفقر ونوائب البطالة من خارج الميدان إلى ولوج هذا المرفق الحيوي دون خبرة أو استعداد أو سابق تجربة.
أمّا الارتجال والتخبّط فعنه حدّث ولا حرج، ومن مظاهره الانقلابات الدائمة في السياسات التعليمية العامة: (نُفَرْنِس نظامنا التربوي مرة، ونُعَرِّبه مرّة أخرى، ثمّ نسلك به سبيل الغراب الموريتاني وهو يحاكي مشية الحمامة البلجيكية) وفي النهاية لم يتَفَرْنَس تعليمنا، ولا هو تعَرَّب، أحرى أن يَتَبلْجك.
لموريتانيا ـ يا قوم ـ واقعها المضطرب، وحياتها الاقتصادية البائسة، ولها أمراضها الاجتماعية المزمنة، وهي غارقة في التخلّف والأمية والفقر والقبلية والوساطة والرشوة وسوء الحكامة، والأمل الوحيد في هذا البحر الهادر من الآلام معلّق على صلاح المنظومة التربوية، والمنظومة التربوية ضائعة في مستنقع آسن. فالحاكم الذي كثيرا ما جاء على ظهر دبّابة حظّه من التعليم ضئيل وإدراكه لمحوريته محدود، ففاقد الشيء لا يعطيه ـ كما يقول علماء التربية ـ ومن ثمّ فقطاع التعليم لا يمثّل أولوية بالنسبة إليه، وقد يملؤك جعجعة دون أن ترى طحينا، كحال سنة التعليم التي تمّ إعلانها منذ بعض الوقت، وانتهت حقيقة أمرها إلى حقيقة أمر المُعَيْدي تسمع به خير من أن تراه!
والمدرّس ـ في الغالب ـ مضرب المثل في الفاقة والازدراء، لا عائد مادة يَرتَجِى ولا اعتبار معنى يُؤمِّل، ولا ملتقيات تكوين أو دورات تحسين خبرة يَنتظِر، فقناعته بالتعليم صفرية واستعداده للتضحية معدوم، وهو في أحسن الحالات كالآلة الصمّاء، يروح ويغدو إلى الفصول ليُفرغ ما في جعبته من دروس أعدّها منذ سنته الأولى في التعليم، بلا مراجعة و لا تجديد و لا زيادة، ينتابه الإحباط ويجلده الندم على اللحظة التي قرّر فيها ولوج هذا المرفق السيزيفي.
أمّا التلميذ، وهو بيت القصيد في العملية برمّتها، فحاله كحال من تقطّعت به السبل في صحراء موحشة جدباء، أو كحال الكرة تتقاذفها أقدام اللاعبين، ركلات من القطاع الوصي ( تتمثّل في نقص المدرّسين الحاد، والتغيّب المتكرّر لبعضهم، وعدم كفاءة الكثير منهم وأخصّ المتعاقدين، وانعدام متابعة وتأطير الموجودين منهم، وفقدان أدوات التدريس ووسائل الإيضاح، وغياب استخدام التقنيات الجديدة في التدريس، وتقادم بعض المقرّرات الدراسية، واكتظاظ الفصول، واعتماد نظام الفترة الواحدة ممّا يرهق التلاميذ ويقلّل مستوى الاستيعاب لديهم، ثم فوضى التقويم وخصوصا في الامتحانات الوطنية...). وركلات من الأهالي ( حين يتقاعسون عن القيام بواجباتهم نحو أبنائهم في البيت من متابعة التحصيل الدراسي، والإشراف على المراجعة، وعدم المساعدة في التغلّب على مكمن النقص، علما بأنّ الوقت الذي يقضيه التلاميذ في المنازل يضاعف مرّات وقت وجودهم داخل المؤسّسات التعليمية، والمثل يقول بأنّ الهدم أسرع من البناء). وركلات من الوسط ( وسائل التسلية والترفيه ممثّلة في الهواتف الذكية والتلفزيونات والألعاب الإلكترونية، هذا إضافة إلى احتمال التأثّر بالرفاق المنقطعين عن التعليم والفاشلين فيه وحتّى برفاق السوء...)
تلك صورة بانورامية مؤلمة عن واقعنا التعليمي، ولئن بدت قاتمة وسوداء فلأنّ عوامل الإخفاق قد تكالبت من نواح عدّة على هذا المشروع الحيوي، الذي هو مرتكز وجودنا وأساس بقائنا، ممّا يحتّم على أيّة معالجة جادّة وموضوعية أن تكشف الستار عن مكمن الداء، لتحاول ـ قدر المستطاع ـ تلّمس وصفة الدواء، تلك الوصفة التي أرى من المهمّ حال الشروع في الأخذ بها وضع الخطوات التالية في الاعتبار.
1 ـ تشكيل هيأة عليا باسم المجلس الوطني الأعلى للتربية والتعليم، إذْ حاجتنا إليه أقوى من حاجتنا إلى أيّ مجلس أعلى سواه، فالتنمية بكلّ أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لا تستطيع أن تقطع أيّ خطوة إلاّ إذا توفّرت القوى البشريّة المؤهّلة للقيام بها. ويتعلّق دور هذا المجلس بوضع الإستراتيجيات العامة للتعليم، تلك التي تخطّط للشكل الذي يجب أن تكون عليه الدولة والمجتمع والاقتصاد والحياة السياسية والثقافية في البلد، وذلك في المدى القريب والمتوسّط والبعيد، ثم العمل الدؤوب مع الجهات المختصّة على متابعة تنفيذها.
2 ـ التزام السلطة المبدئي والصارم، ومهما كانت الظروف بعزل التعليم عن الانقلابات السياسية، وجعله يمثّل وجه الدولة المستمرّ والمتراكم، مع ضرورة البحث عن العقل المناسب ليقود حقيبة التعليم بشكل خاص، على أن يُعطى كامل السلطة لتنفيذ توصيات المجلس الوطني الأعلى للتربية والتعليم، بعيدا عن روتين الإدارة وضغط أصحاب النفوذ.
3 ـ عدم ترك مهمّة النهوض بالتعليم على كاهل الجهات الرسمية لوحدها، وإنّما على المواطن نفسه والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين أخذ زمام المبادرة، كلٌّ من ناحيته، لمواجهة وتحدّى صعوبات التعليم الجمّة التي تعيق مسيرة نجاح الأبناء، والعمل على استيعابها والبحث لها عن الحلول الناجعة.
4 ـ فرض التعليم باللغة العربية في كافة مستوياته، والعودة إلى تدريس المواد العلمية بها، باعتبارها اللغة/ الأم، التي لا تمثّل عقبة أمام فهم التلميذ للمحتوى الدراسي، ولأنّها لغة أغلب ساكنة البلد، وهي اللغة الرسمية كما نصّ عليه دستور الوطن، مع تشجيع تدريس اللغات الوطنية، وإعطاء اللغات العالمية الكبرى كالانجليزية والفرنسية عناية خاصة.
5 ـ تحسين الوضعية المادية والتربوية للمدرّسين والمؤطّرين باقتطاعهم رواتب مجزية، وإخضاعهم بشكل دائم لدورات تدريب وبعثات تفتيش وملتقيات تحسين الخبرة.
6 ـ التوقّف الفوري عن الاستعانة بالمدرّسين العقدويين، واكتتاب ما يلزم من مدرّسي الإطار وتزويدهم بالمعارف والخبرات الضرورية، مع أخذ كامل الحيطة ليتمّ الاكتتاب في ظروف جيّدة تضمن الشفافية والدقّة المهنية، وهنا أيضا يلزم استعادة المفرّغين، والكفّ عن تسييب المكتتبين أو إحالتهم إلى قطاعات أخرى لا تمتّ إلى مجال تخصّصهم بصلة.
7 ـ تنشيط جهات الرقابة والتسيير والإشراف، من مفتّشيات وإدارات مركزية وجهوية ومدّها بالوسائل المادية واللوجستية لأداء مهامّها على أحسن وجه.
8 ـ توسيع تجربة مدارس الامتياز لتحقيق تعليم نوعي يسمح للأذكياء من التلاميذ بشقّ طريقهم نحو دنيا الموهبة والابتكار.
9 ـ إخضاع مؤسّسات و"حوانيت" التعليم الحر لرقابة صارمة، وسحب الرخصة من تلك التي لا تستجيب للشروط والضوابط المهنية المنصوص عليها في دفتر الالتزامات.
10 ـ وضع سياسة صارمة لإقامة البنية التحية في المناطق المختلفة على أسس دقيقة وموضوعية، تراعي الحاجات الضرورية وتعتمد سياسة التمييز الإيجابي لصالح الفئات الهشّة.
11 ـ التغلّب على مشكل الاكتظاظ، والعدول عن نظام الفترة الواحدة المجحف بالتلميذ والمدرّس على السواء إلى نظام الفترتين الصباحية والمسائية المريح لهما، من خلال توفير ما يكفي من الحجرات الدراسية وطاقم التدريس والتأطير.
12 ـ تحيين المقرّرات الدراسية ومراجعتها وتمحيصها بشكل دائم، لجعلها تواكب مسيرة التطور العلمي من جهة، وتستجيب لخصوصية الدولة الموريتانية وقيّمها وحاجاتها الملحّة من جهة ثانية. مع الحرص على أن تبتعد هذه المقرّرات عن منهج التلقين، وتركّز على جعل التلميذ يفكّر بطريقة متكاملة، تُعطيه حرية الاختيار طبقا لما يرضي قناعته ومهاراته الشخصية، وبالتالي يستطيع لاحقا أن يبدع إن هو تخصّص في المجال الذي اختاره لنفسه واقتنع به.
13 ـ توفير ما يلزم من الكتب الدراسية المقرّرة والمعدّات والأدوات الضرورية لنجاح المهمّة التعليمية
14 ـ الاستفادة ممّا توفّره ثورة التقنية والإعلام الآلي ونظام الحاسوب في مجال تطوير أنظمة التربية والتعليم.
15 ـ تزويد المدارس في المناطق الهشّة ( آدوابه والقرى والأرياف النائية ) بالكفالات المدرسية التي توفّر للتلاميذ الفقراء حاجتهم من الطعام والملبس والأدوات المدرسية.
16 ـ تشجيع المدرّسين في تلك المناطق بعلاوات تحفيزية مرغّبة، تجعلهم يستقرّون هناك ويطمئنّون إلى أداء مهامّهم في تلك الظروف الصعبة.
17 ـ تفعيل وزيادة المعاهد المتوسّطة لاستيعاب التلاميذ الذين لم يفلحوا في مواصلة مسيرتهم التعليمية، وتوجيههم نحو إتقان مهن مدرّة للدخل كالميكانيكا والكهرباء والخياطة والنجارة واللحامة...
18 ـ تشجيع البحث العلمي على المستوى الجامعي، وعدم اكتفاء خريّجي الجامعات بتحصيل الشهادات، بل لا بدّ من المواءمة بين المناهج الدراسية وبين ما يؤهّل الطالب لولوج سوق العمل، وفي ذلك يكمن الفرق بين المجتمع الاستهلاكي والمجتمع الإنتاجي الذي يجعل من المعرفة جسرا يوصل لحياة إنتاجية.
19 ـ وعي خرّيجي الجامعات أنّ القطاع العام ليس نهاية المطاف في هذه الحياة، بقدر ما قد تتحقّق الفرص الجيّدة في القطاع الخاص الحيويّ والفعّال، ولهذا فعلى كلّ مستويات التعليم أن تغرس في المتعلّم روح التعلّم المستمرّ عن طريق الدورات والتأهيل حسب حاجات السوق ومطالب القطاع الخاص داخلها.
20 ـ إعلان جائزة سنوية لخيرة المدرّسين والمؤطّرين والتلاميذ الذين تميّزوا في أدائهم، تحفّز الجميع على روح الجدّ والتضحية والمنافسة الإيجابية.
21 ـ إدخال استراتيجية اجتماعية فاعلة في نظامنا التربوي، تستهدف معالجة الاختلالات المهدّدة للنسيج الاجتماعي كالعنصرية والتراتبية والنظرة الدونية، من خلال السهر على تقوية ضارب التربية المدنية، وتقديمها بشكل فعّال، يؤسّس لثقافة المواطنة ومبادئ العدل والمساواة، ويرسيخ دولة القانون. ويجعل المتعلّم في مؤسّساتنا يتعلّم لا ليعرف ويعمل فقط، وإنما لعيش حياة الأخوة والانسجام والمودّة والاحترام مع الأخرين.
22 ـ إشراك رابطات آباء التلاميذ كمتدخّل فاعل في مفاصل المنظومة التربوية، وكشريك فعلي في خدمة مصلحة التلميذ، ثمّ كقوّة اقتراحية إلى جانب الإدارة والطاقم التربوي قادرة على مدّ جسور التواصل بين المؤسّسات التعليمية والأسر، ونسج العلاقات بينها من أجل تطوير خدماتها والمساهمة في إشعاعها الاجتماعي والثقافي والفني.